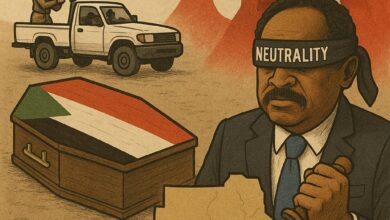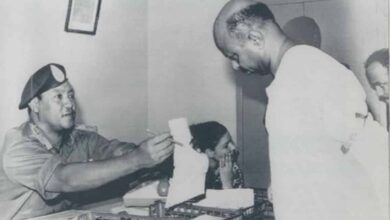روية تحالف صمود لوقف الحرب في السودان: تناول نقدي

د. أمجد فريد الطيب
بينما يستمر السودان، منذ اندلاع الحرب المدمرة في أبريل ٢٠٢٣، في مواجهة قضايا مصيرية تتشابك فيها خيوط الأزمة الإنسانية الطاحنة مع تعقيدات المشهد السياسي والأمني، لتُلقي بظلالها الكثيفة على مستقبل البلاد، تستمر بعض المجموعات المدنية في محاولات حثيثة لإعادة تقديم نفسها في الساحة السياسية دون اتخاذ مواقف واضحة تنحاز لمصلحة الشعب السوداني في إيقاف الحرب، بل تنحاز لصالح الترويج لنفسها وكأنها سلعة معروضة في سوق بيع وشراء سياسي عبر ترديد عموميات سياسية تتفادى مواجهة الواقع لصالح تقديس الشعار.
تبرز الوثيقة التي أصدرها تحالف “صمود” في منتصف شهر يونيو ٢٠٢٥، والمعنونة “رؤية سياسية لإنهاء الحروب واستعادة الثورة وتأسيس الدولة”، كمثال بارز على هذه الظاهرة. فالوثيقة المطولة، التي تبدو في ظاهرها محاولة للخروج من عنق الزجاجة، تظهر في حقيقتها كإعلان تلفزيوني مبهرج من تسعينيات القرن الماضي لترويج منتج غير موجود أصلاً، وكأنها تستلهم فيلم الفنان الكبير عادل إمام عن “الفنكوش”.
النظر إلى رؤية “صمود” حول إيقاف الحرب يجعلنا نجدها تمثل “فنكوش” السياسة السودانية بلا منافس. ففيها تتوارى ثلاث مفارقات تكشف زيف الشعارات وتؤكد عمق الأزمة:
١. مفارقة الشرعية وشرعنة العنف: ترفع الوثيقة راية الحكم المدني، لكنها تخفي تحتها شرعنة المليشيات.
٢. مفارقة المساءلة والاستخدام الانتقائي لشعارات العدالة: تندد بجرائم نظام الإنقاذ القديم، لكنها تسكت عن فظائع الدعم السريع اليوم، في ازدواجية تجعل من العدالة محض شعارات وحبراً على ورق.
٣. مفارقة التمثيل: تتغنى بالديمقراطية، بينما يسعى واضعوها إلى احتكار السلطة.
وهي مفارقات سنتناولها بمزيد من التفصيل فيما يأتي:
المغالطة المعرفية في تشويش جذور الأزمة وتداعياتها
حاولت وثيقة “صمود” تصوير الحرب الدائرة في السودان على أنها امتداد للنضالات السودانية، وليست نتيجة لأفعال الدعم السريع ومحاولته الانقلابية في ١٥ أبريل ٢٠٢٣، بل تعكسها على انها امتداد لصراع طويل بين قوى التغيير الديمقراطي وقوى الاستبداد، وأن جذور هذه الحرب عميقة في التاريخ الوطني، ولها أبعاد سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية، تمثلت في أزمة حكم مزمنة. صمود هنا تحاول تبرير وشرعنة حرب الدعم السريع بربطها بالنضالات السودانية من أجل الديمقراطية والثورات المسلحة السابقة لمناطق الهامش ضد المركز، دون أن تُلقي بالاً إلى حقيقة أن الدعم السريع بقيادته وتشكيله الحاليين كانا أحد أفظع أدوات القمع ضد التطلعات الديمقراطية للسودانيين. بل إن ظهورها المؤسسي الأول بعد إنشائها كمليشيا خاصة بواسطة الرئيس المخلوع عمر البشير كان لقمع انتفاضة سبتمبر ٢٠١٣ في مواجهة النظام القمعي الحاكم حينها، ثم تخصصت في نشر الرعب والفوضى في أطراف الهامش السوداني من دارفور وشمال وجنوب كردفان، حتى تم تصنيفها كأحد عوامل عدم الاستقرار الدائمة في تقارير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة بين أعوام ٢٠١٤ وحتى ٢٠١٨. فكيف يستقيم تصوير محاولتها الانقلابية التي أدت إلى إشعال هذه الحرب على أنها استمرار لنضالات الشعب السوداني من أجل الديمقراطية؟
وبينما تُقدم الوثيقة سردية عامة لتراكم الأزمات، فإنها تُغفل الإشارة إلى تفاصيل بالغة الأهمية في المشهد السياسي الذي سبق الانفجار. فبعد ثورة ديسمبر 2018-2019، التي أطاحت بنظام عمر البشير، تشكّل تحالف معقد بين المكون العسكري والقوى المدنية. هذا التحالف، الذي كان بطبعه هشاً ومتوتراً، شهد صراعاً خفياً ومكشوفاً على السلطة والصلاحيات. وزاد من تعقيد الوضع أن القوى المدنية لم تكن كتلة واحدة؛ بل كانت تعاني من انقسامات داخلية حادة، وتنافساً محموماً بين مكوناتها على التمثيل والقيادة. هذا التنافس، والنزوع نحو “احتكار السلطة” من قبل بعض المكونات، أضعف الجبهة المدنية وجعلها عرضة للاختراقات العسكرية، خصوصاً أن بعض هذه القوى لم تستنكف عن الحج اليومي إلى مكاتب العسكر والاستقواء بهم ضد رفاقهم المدنيين الآخرين كلما اشتعلت الخلافات.
في أكتوبر 2021، جاء الانقلاب الذي أطاح بالحكومة المدنية الانتقالية. لم يكن هذا الانقلاب مجرد حدث عسكري مفاجئ، بل كان تتويجاً لشهور من التوتر والتعبئة المضادة. تلا الانقلاب محاولات عدة لاعادة المشهد السياسي، ولم تكن قوى النظام القديم وحزب المؤتمر الوطني المخلوع وحدهما هما اللذان استقويا بالعسكر، بل إن ما تبقى من القوى المدنية التي تنتظم الآن في “صمود” تماهى بشكل كامل مع الدعم السريع، وهو ما زاد من حدة التوتر بين قائدي الجيش والدعم السريع، البرهان وحميدتي، حيث كان كل منهما يخشى على نفوذه ومستقبله في الترتيبات الأمنية الجديدة. وكان الخلاف حول مستقبل الدعم السريع، وهي نفس النقطة التي تتفادى روية صمود الاشارة اليها، الشرارة المباشرة التي أشعلت فتيل الحرب في 15 أبريل 2023، بعد تحركات قوات الدعم السريع لمحاصرة القاعدة الجوية في مروي والاستيلاء على حكم البلاد بالقوة لحماية وجودها المستقل. إن هذه الديناميكيات الداخلية المعقدة، والنزاعات حول السلطة والنفوذ بين القوى المدنية والعسكرية، هي التي مهدت الأرضية للحرب، وليس فقط “الحركة الإسلامية” وحدها.
تناول الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين: وصف دقيق وسؤال غائب عن الفاعل الرئيسي
تُبرز الوثيقة الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي خلفتها الحرب، وتصفها بأنها “الأكثر فداحة على مستوى العالم”، مع تعداد الانتهاكات الجسيمة من “قتل ونهب واغتصاب وقصف جوي ومدفعي”. وتشدد على ضرورة معالجة هذه الكارثة وحماية المدنيين عبر حزمة من الإجراءات، بما في ذلك المساءلة الدولية وتجفيف موارد تأجيج النزاع. ولا خلاف بالطبع على حجم الكارثة الإنسانية وبشاعة الانتهاكات. لكن اللافت للنظر في هذا الجزء المهم هو غياب الإشارة المباشرة والصريحة إلى الجهة الرئيسية المتسببة في هذه الكارثة ومرتكبة معظم جرائمها والجهات الداعمة لها. فبينما تتباكى الوثيقة على معاناة المدنيين، فإنها لا تُخبرنا من الذي يتسبب فيها ويرتكب أغلب جرائمها. هنا، لا يسعنا إلا أن نعود إلى تقارير موثقة مثل تقرير مشروع تسجيل بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة (ACLED) الصادر في نوفمبر 2024، والخاص بالعنف والانتهاكات ضد المدنيين في السودان، والذي أشار إلى أن مليشيا قوات الدعم السريع كانت مسؤولة عن حوالي 77% من هذه الحوادث، بما في ذلك عمليات القتل الجماعي، والاغتصاب المنظم، وتدمير البنية التحتية. وهو ما يجعل الوثيقة تعكس قصوراً منهجياً في تحليلها للكارثة الإنسانية. فبينما تُفصّل آثار الجرائم، فإنها تتجنب تسمية الفاعل الرئيسي بوضوح. هذا التجنب يُشكل فجوة منطقية خطيرة في أي رؤية تسعى لوقف الحرب ومعالجة آثارها. فكيف يمكن وضع خطط حماية ومساءلة دون تحديد الطرف المسؤول بشكل أساسي؟ إن مواجهة الحقيقة بدلا من السعي لتطويعها هي الخطوة الأولى نحو أي حل جاد، وإن تجاهل هذه الحقيقة في وثيقة تهدف إلى “تأسيس الدولة” و”إنهاء الحروب” يُثير علامات استفهام جدية حول مدى موضوعية الرؤية وجديتها في معالجة جوهر الأزمة. تجاهل تحديد مرتكبي الانتهاكات هو تكرار لأخطاء الماضي التي سمحت بالإفلات من العقاب.
وكما تطرح الرؤية، في معرض تناولها للكارثة الإنسانية، مقترح تعيين مبعوث أممي/إقليمي، وهو مقترح يعيد صدى ما طُرح سابقاً خلال مؤتمر لندن في أبريل الماضي، والذي فشل آنذاك في نيل التوافق اللازم لإقراره. وتُعيد الورقة طرح هذا المقترح الآن في ثوب سوداني، على أنه مبادرة وطنية خالصة. غير أن المقترح في حقيقته يُكرّس مزيداً من التعدد في المنابر والتدخلات الدولية في الشأن السوداني، وهو مشهد مكتظ أصلاً بمبادرات خارجية متعددة. ويبدو أن هذا الطرح يأتي في سياق امتعاض تحالف “صمود” من أداء المبعوث الأممي الحالي، الجزائري رمطان لعمامرة، ومحاولة للحد من صلاحياته وتقليص نطاق ولايته الأممية على السودان، في استمرار للاستغلال السياسي لخطاب الازمة الانسانية.
مصير الدعم السريع: “الفيل في الغرفة”
تُشير الوثيقة على امتداد صفحاتها الستة إلى مليشيا قوات الدعم السريع بشكل مباشر أو غير مباشر مرتين فقط، في حين أوردت ذكر القوات المسلحة الوطنية أو المؤسسة العسكرية ثماني مرات. وقد فصلت في رؤيتها لإصلاح المؤسسة العسكرية وإعادة تأسيسها، ولكنها لم تُخبرنا ماذا تفعل بالدعم السريع تحديداً. كما تفادت الرؤية الإشارة إلى مصير مليشيا الدعم السريع وهي تتحدث عن وقف الحرب، وكأنما هذه الحرب تدور بين طرف واحد مع نفسه.
بأي حال من الأحوال، تُعد مليشيا الدعم السريع طرفاً رئيسياً ومُفصلياً في هذه الحرب. نشأت هذه القوات كمليشيات “الجنجويد” التي استخدمها نظام الإنقاذ في دارفور، ثم تم “شرعنتها” بقرار من البشير كقوة دعم للقوات المسلحة، لتتحول لاحقاً إلى قوة موازية شبه مستقلة تتمتع بنفوذ اقتصادي وسياسي كبير. الحرب في أبريل 2023 بدأت بمحاولة انقلابية قامت بها هذه المليشيا بعد تحركات قواتها لمحاصرة القاعدة الجوية في مروي. إن وجودها أصلاً هو أمر غير طبيعي مع هيكلة الدولة. وأي رؤية للسلام لا تُعالج مصير هذه القوة ومستقبل وجودها ضمن أي هيكل عسكري مدني، تُعد قاصرة وغير واقعية.
إن هذا التجاهل الصارخ لمصير مليشيا الدعم السريع، وهي طرف أساسي في هذه الحرب، يجعلنا نتساءل: كيف يمكن لـ “رؤية سياسية” تهدف إلى إنهاء الحروب أن تتفادى الإشارة إلى مصير أحد أبرز أطراف النزاع؟ هذا التجنب الواضح يُوحي باستمرار مداعبة الطموحات السياسية لقيادة قوات الدعم السريع والجهات الخارجية الداعمة لها. ويبدو واضحاً أن هذا الغموض ينبع من رغبة واضحة في استمرار ابتزاز السودانيين بسلاح وبطش المليشيا لتحقيق طموحات بعض السياسيين في السلطة. وقد بدا تأثير خطاب قائد قوات الدعم السريع، حميدتي، الأخير الذي قال فيه “لا مكان للمواقف الرمادية وإما معنا أو ضدنا”، واضحاً على كتاب الرؤية، فتفادوا ذكر أي موقف قطعي عن المليشيا. إن السعي المستمر لاحتكار الصوت المدني، وتمثيل أنفسهم على أنهم الممثلون الوحيدون للسودانيين، لم يكن خطيئة كافية، بل واصلوا الخطأ بمحاولة استعمال هذا الصوت المدني لتبرير الوجود المؤسسي للمليشيا المتحالفة معهم بمذكرة تفاهم أو اتفاق حمدوك-حميدتي في أديس أبابا يناير 2024. إن هذا التناقض بين الحديث عن بناء دولة مدنية وشرعنة وجود مليشيا خارجة عن سلطتها، يُعد تناقضاً منطقياً صارخاً يطعن في جوهر الرؤية. إن وجود قوة عسكرية موازية للدولة هو نقيض لمفهوم الدولة الحديثة وسيادتها.
استمرار التناقضات
تتباكى الوثيقة على إرث نظام الإنقاذ، وتتحدث عن ثورة ديسمبر ، وتدعو إلى “سلطة انتقالية مدنية كاملة، بدون مشاركة العسكريين”. كما تتحدث عن “رفض إغراق العملية السياسية بواجهات مزيفة أو مصنوعة”.
بعد ثورة ديسمبر، تقاعست القوى المدنية عن -او بالاصح تجاهلت- تكوين المجلس التشريعي الذي يُعد حصناً ديمقراطياً أساسياً، ويُفترض أن يكون الممثل لأوسع طيف من الشعب. بدلاً من ذلك، ساد نزوع لدى بعض مكونات قوى الحرية والتغيير إلى احتكار السلطة التشريعية لكياناتها الحزبية عبر ما عُرف بـ “المجلس المركزي”، ثم محاولة تعديل الوثيقة الدستورية لتكوين ما عُرف بـ “مجلس الشركاء”. هذه الممارسات، التي اتسمت بالانتقائية والنزعة الاحتكارية، أضعفت الثورة من الداخل، وأثارت حفيظة قوى سياسية واجتماعية أخرى، وفتحت الباب أمام الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر 2021. هذه الصراعات الداخلية والتنافس السياسي وراء المصالح الذاتية والحزبية هي التي أفسدت مسار الفترة الانتقالية، وليس فقط مؤامرات نظام الإنقاذ القديم.
إن الوثيقة، وهي تمجّد ثورة ديسمبر، لا تُخبرنا “لماذا فشلت هذه القوى نفسها في تحقيق شعاراتها وأهملت تكوين المجلس التشريعي” وحاولت احتكار السلطة، “وكأنما الدولة غنيمة”. هذا يُشكل تناقضاً بين السردية التاريخية للوثيقة والواقع الممارس من قبل بعض أطرافها. علاوة على ذلك، فبينما تُنادي الوثيقة بـ “سلطة انتقالية مدنية كاملة، بدون مشاركة العسكريين”، فإن قادة التحالف الذي أصدرها لا يزالون يدافعون وينافحون عن مسودة اتفاق المنامة الذي لم يتجاوز كونه اتفاقاً لتقاسم السلطة بين طرفي الحرب وتأسيس وشرعنة وجودهما في الساحة السياسية. إن التباين الصارخ بين الدعوة إلى المدنية الكاملة والرضوخ لاتفاقات تُشرّع وجود الأطراف العسكرية المتحاربة، يُفقد الوثيقة مصداقيتها ويُظهر ازدواجية في المعايير. كما أن حديث الوثيقة عن “رفض إغراق العملية السياسية بواجهات مزيفة أو مصنوعة” يتناقض مع “تجاوزهم للقوى النقابية المنتخبة وصناعة بدائل موالية لهم لزجها في تحالفاتهم”. وهذا التناقض يُظهر أن المصالح الحزبية قد طغت على المصلحة الوطنية.
كتابة مبهرجة وغياب آليات التنفيذ والالتزام
تضع الوثيقة مجموعة من الأسس والمبادئ الطموحة لبناء الدولة، مثل وحدة السودان، المواطنة المتساوية، الدولة المدنية الديمقراطية الفيدرالية، العدالة الانتقالية، بناء منظومة أمنية وشرطية مهنية وقومية تخضع للسلطة المدنية، ومكافحة الفساد، وغيرها. وعلى الرغم من أهمية هذه المبادئ، إلا أن الوثيقة تُعاني من ضعف في تفصيل آليات التنفيذ وكيفية تحقيق هذه الأهداف السامية على أرض الواقع، خاصة في ظل التعقيدات الراهنة. فقد تحدثت الوثيقة كثيراً وطويلاً “دون أن تقول أي شيء” عملي حول “كيفية إيقاف الحرب”، ودون أن تواجه أهم أسئلتها وهو مصير مليشيا قوات الدعم السريع”.
إن تجميل المبادئ دون تقديم خريطة طريق واضحة، والتهرب من الأسئلة المحورية حول كيفية إيقاف الحرب في السودان، يُفقد الرؤية جدواها. فالتركيز على المبادئ العامة مع التهرب من التحديات المحددة، يُشبه بناء قصور في الهواء. وما يكشف حقيقتها بأنها ليست سوى مواصلة محاولة لتوسل كراسي السلطة عبر سلاح المليشيا”، وهي جريمة في حق الشعب السوداني لا تقل في حجمها عن حاملي السلاح ومطلقي الصواريخ والقنابل”.
لا سبيل لإيقاف الحرب في السودان أو إيجاد أرضية مشتركة للاتفاق بين السودانيين دون مواجهة سؤال الوجود المؤسسي لمليشيا قوات الدعم السريع وضرورة إنهائه بكافة امتداداته السياسية والاقتصادية والإثنية. إن أي رؤية جادة لإنقاذ السودان يجب أن تتسم بالوضوح والشجاعة في مواجهة الحقائق كما هي على أرض الواقع، وأن تُعلي من مصلحة الوطن والمواطن فوق أي طموحات سياسية ضيقة أو تحالفات ظرفية. كما قال الفيلسوف السياسي الروماني شيشرون: “الحقيقة تُكره، لكنها تُحب أيضاً”. والتهرب من الحقيقة، خاصة في أوقات الأزمات الكبرى، لا يُمكن أن يُفضي إلى حلول مستدامة.